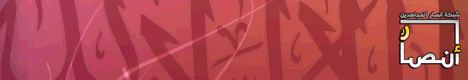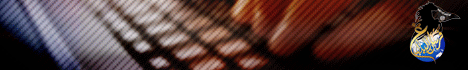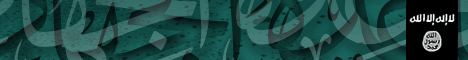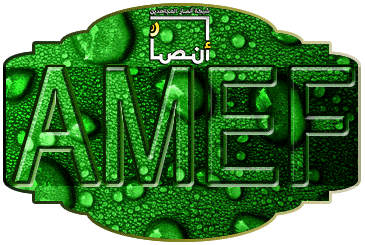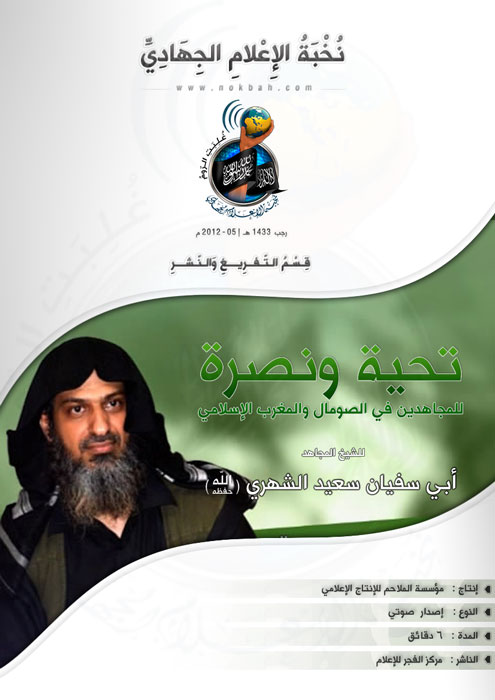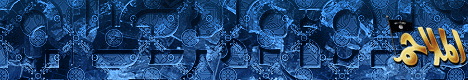الحمد لله القائل ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (فصلت: 30)، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فإن مفهوم الإيمان في ديننا أشمل وأوسع مما هو شائع لدى عامة المسلمين بل حتى لدى بعض خاصتهم، حيث أنه يشتمل على جانب نظري اعتقادي وجانب عملي تطبيقي، فهو مفهوم السلف الصالح: قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، فزيادته ونقصانه مرتبطان بالعمل مباشرة (يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي)، فلا معنى لإيمان بلا عمل كما أنه لا معنى ولا قيمة لعمل بلا إخلاص ومتابعة.
ولقد جاء في القرآن الكريم ذم للفئة التي تحصر الإيمان في مجرد القول دون العمل، وذلك في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾(الصف: 3)، ولا شك أن الله تعالى يطلب من المؤمن أن يبرهن على صحة إيمانه في هذه الدنيا التي تعتبر مرحلة امتحان واختبار لهذا الانتماء، وتصديق لهذا الادعاء أو تكذيبه:﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾(الملك: 2)، ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾(الكهف: 7)، فلا يكفي أن يدَّعي المرء الإيمان بمجرد القول أو الاعتقاد، لأن هذه عقيدة فاسدة جرَّت على الأمة الكثير من المصائب، وتسببت في تمكن الأعداء من رقاب العباد وخيراتهم، وذلك حينما اكتفوا بإيمان أعزل تواكلي لا يعطي للجانب العملي أي قيمة تذكر.
إنها عقيدة الإرجاء في مسمى الإيمان، وتلك هي بعض نتائجها الوخيمة على الأمة، حتى صار الناس لا يستطيعون التمييز بين الكافر الأصلي وبين المرتد، بل لقد حكموا بإسلام هذا الأخير لمجرد أنه ادعى أنه مسلم بلسانه حتى وإن ناقض هذا الإسلام بعمله، بل لقد بايعوا هؤلاء الحكام المرتدين ومكنوهم من الحكم وتحولوا إلى أنصار لهم يدافعون عنهم ويصبغون عليهم الشرعية، فهدموا بذلك عقيدة السلف في مسمى الحكم، وذهبوا إلى أبعد من هذا، حينما نادوا إلى ما أسموه “حوار الأديان”، واعتبار الكفار الأصليين مؤمنين، كونهم أهل كتاب، فأسقطوا بهذا عقيدة الولاء والبراء، وشوهوا مفهوم الجهاد حينما حصروه في مجرد جهاد الدفع، وسموا جهاد الطلب بالإرهاب وتبرءوا منه ومن كل المجاهدين.
أما الإيمان المقبول عندهم فهو الانصياع لأولي الأمر، والسعي إلى المشاركة في العمل السياسي لإصلاح النفوس ودعوتها إلى مكارم الأخلاق والكف عن التدخل في شؤون الناس – كل الناس – سواء كانوا ظالمين أو مظلومين، عصاة أو طائعين، مصلحين أو مفسدين، فشعارهم هو الحديث الشريف – الذي فهموه بالمقلوب-: “من حسن إسلام المرء (وفي رواية: من حسن إيمان المرء) تركه ما لا يعنيه”.
إن الإيمان الذي ندعو الناس إليه هو الانصياع لله عز وجل وللحق الذي أنزله، دون محاباة أو خشية أحد، وهو الإيمان الذي يدعو صاحبه إلى ترك ما يتناقض مع مبادئه وهجر كل المعوقات التي تقف في طريق انتمائه للدين الجديد، والزهد في كل شيء مهما ثقل وزنه وعلا شأنه في دنيا الناس.
إيمان يدعو صاحبه إلى التضحية والصبر والمصابرة، وإلى مواجهة المخالفين ومجابهتهم والانتصار عليهم وعلى إغراءاتهم وإرهابهم.
إيمان يدفع صاحبه ويجعله قادراً على الجهر بالحق الذي يؤمن به، حتى وإن كان أكثر الناس لا يقبلون ما يدعوهم إليه، ويجعله معتزاً وفخوراً بما يحمله من مبادئ وقيم تخالف ما يعتقده القوم من حوله.
إن الإيمان في زمن غربة الإسلام الثانية عملية معقدة وصعبة للغاية، فهي تشبه عملية القبض على الجمر، لابد من الصبر على أذى حرارتها لتبقى مشتعلة أو على الأقل متوقدة وإلا انطفأت.
نحن نريد إيماناً أشبه بإيمان العجائز في ظاهره، بحيث لا يتزعزع المرء عن ثباته، ويزداد مع الابتلاء والمحن تجذراً وترسيخاً في القلب، ولكنه يتميز عن إيمان العجائز في جوهره، بحيث يكون سليماً وموافقاً لإيمان السلف الصالح، بعيداً عن البدع والانحرافات التي نجدها لدى عجائزنا بسبب الجهل الموروث.
ولقد نجح الأعداء لفترات طويلة وفي مناطق شاسعة ومتعددة من بلداننا أن ينشروا بدعاً كثيرة ومغريات متعددة لصرف المسلمين عن الممارسة الحقيقية لدينهم، في شتى مجالات الحياة اليومية للمسلم، وأصبح الالتزام عندنا صورياً وإسمياً لا غير، وحاولوا إغراقنا في الشهوات لكي لا نضحي في سبيل ديننا، فيصير لدينا أرخص من جناح بعوضة، نضحي به في سبيل تحصيل فتات الدنيا الزائل.
هذا في الوقت الذي يضحي فيه المسلمون بأغلى ما يملكون وعلى رأسها حياتهم، من أجل التكالب على هذه الدنيا والحرص عليها.
.. ثم استقم
ليس المهم أن تؤمن، بالرغم من أهمية هذه النقلة وصعوبتها في آن واحد، ولكن الأهم هو الاستمرار والثبات على هذا الإيمان، وهو ما يسمى بالاستقامة.
فالاستقامة شرط أساسي على صحة الإيمان، فعن أبي عمرة سفيان بن عبد الله t قال، قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك، قال: ” قل آمنت بالله ثم استقم” [رواه مسلم].
هكذا الإسلام ، يجعل الاستقامة بعد الإيمان مباشرة ، بل لا معنى لهذا الإيمان بدون استقامة.
وفي الحديث المشهور حيث قال رسول الله r: ” شيبتني هود وأخواتها، وشيبني في هود قوله تعالى ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾(هود:121)، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
انظروا إلى ثقل مسؤولية اتباع أمر الله، ﴿ كَمَا أُمِرْتَ ﴾، أي كما أمر الله تعالى، وليس اتباع الهوى أو النفس أو الابتداع في الدين ما لم ينزل به الله .
ولاشك أن للعبادات اليومية والموسمية دورا كبيرا في تربية المسلم على الاستقامة، كالصلاة مثلاً، حيث يضطر المؤمن إلى تكرار هذه العبادة عدة مرات في اليوم والليلة لكي يبقى على اتصال مستمر مع ربه من أجل الدعاء وطلب المغفرة والمدد، فهي أشبه بمحطات استراحة وتزود، لمواصلة المسير.
وعملية الصوم هي الأخرى تربي المسلم على الصبر وامتلاك زمام نفسه وكبح جماحها عن الشهوات والإسراف في الحلال، وهاهو رمضان على الأبواب، وهو فرصة جديدة لكل مؤمن بأن يجعل هذا الشهر مدرسة لتحصيل الصبر وتعويد النفس على الاستقامة على طاعة الله عز وجل، في السر والعلن، في السراء والضراء وفي المنشط والمكره.
فالاستقامة درجة أعلى من درجة الإيمان، لأنها تطالب صاحبها